Views: 11
زيارةُ طائرٍ لطيف
أيُ سرٍ فيكَ …. يا لقاحُ
ما أتذكرهُ جيدًا أني لم أجزع لسماعِ صوتِه ، ولا فزعٍ انتابني ، ولكن دهشةً كبيرةً امتلأ بها وجهي ، وبهجةً لم أر لها مِن قبلُ مِثيلًا في قلبي ـ حتى مِن قبلِ أن أسمعَ صوتَه ـ صاحَبتها قشعريرةٌ اهتز لها سائرُ بدني .. فقد كانتْ نقراتُه على الزجاجِ الصغيرِ الممتلئةِ به نافذةُ ” الكُشك الخشبي ” في وسط الحديقةِ ، لتوحي لأولِ وهلةٍ بأنه زائرٌ ، وأنه يطرقُ بابَ قلبي ليحدثني ، ولم تمضِ لحظةٌ حتى سمعتُ صوتَه الرقيقَ جدًا يسري في كاملِ جسدي لا في أُذنَيَّ وحسب ، لقد اخترقني كلي :
ـ هل تسمحُ لي بمحادثتك قليلًا ؟.
بكلِ صدقٍ لم يستطع صوتي أن يخرج ، لكنني فورًا سارعتُ في فتحِ النافذةِ حتى يدخل ” الهدهدُ الجميلُ ” الذي طالما رأيتُه بجوارِي ينقرُ أرضَ الحديقةِ بمنقارٍ كأنه من حديدٍ ، كم كان منظرُه جميلًا ، حيثُ كان ريشُه يتلألأُ ضياءً مِن نظافتِه ، ويالها من كسوةٍ جميلةٍ تُغطي عنقه كأنها حُلِيِّةٌ صُنِعَتْ مِن ريشٍ كتلك التي تعلو رأسَه كأنها التاج .. كان يبدو لي تمامًا صِغَرُ سِنِهِ ، إلَّا أنه تخطى منذُ عهدٍ قريبٍ مرحلةَ الطفولةِ .. كان شوقي الرهيبُ لحديثِه وسماعِ صوتِه ولطريقةِ حوارٍه ، مع لحظةِ صمتِ انتظارِ ذلك كله ، إنما يجيشُ في صدري ما يُوَلِّدُ تيارًا من تفاعلاتٍ وعواطفَ وأحاسيسَ شتى متضاربةٍ ، فكم مِن خاطرٍ مرَّ بخاطري في تلك البرهةِ مِن الزمنِ التي لم تستغرق أصلًا سوى حركةِ ” الهدهدِ ” في الاستواءِ على مسندِ الكرسيِ قُبالَتي ، وها هو ينظرُ إليَّ بنظرٍ صائبٍ غيرِ زائغٍ ولا مخطئٍ .. يالهول اللحظةِ التي أنستني ما قبلها مِن ضجرٍ وضيقٍ ، ومِنْ تفكيرٍ بصوتٍ عالٍ وصلَ حد الصياحِ أحيانًا ، إلَّا أنها لحظةٌ أراها تتلاشى هي الأخرى أمام هولِ لحظةٍ أخرى تلتها مع بدءِ خروجِ أول حرفٍ مِن فيه بعد اللقاءِ والمواجهةِ :
ـ أرى الدهشةَ تملأُ وجهَ سيدي .
لا أُخفي أني أغمضتُ عينيّ متعمدًا لأستجمعُ كلَ حواسي لاستقبالِ كلامِه بعد أن استقبلتُ صوتَه .. كان سؤالُه يتطلبُ مني البدءَ في الكلامِ حتمًا لكنَّ لساني كان شبهَ منعقدٍ ، ولولا فَرْقِي مِن هجرِه ومفارقتِه أمامَ صمتي لَمَا تجشمتُ قطُ وبدأتُ الكلامَ معه .
ـ رغم سعادتي بزيارتِك وبكلامِك معي ، إلَّا أنَّ لديَّ فضولًا في معرفةِ سببِ اختيارِكَ لي واختصاصي بذلك .
لم يرد الهدهدُ على سؤالي مباشرةً بل صمتَ برهةً ، صوَّبَ فيها نظرَهُ إليَّ بأكثرِ مما كان وكأن إجابتَهُ سوف تكونُ لاذعةً ، ولقد كانت بالفعلِ حتى كأن الدوارَ قد التف حول رأسي :
ـ ولمَ أسميتَهُ اختيار .. ألا قد يكونُ قدرًا ؟
أمامَ لمعانِ عيناي ، وقشعريرةٍ وقفَ لها شعرُ رأسي ، أخذ ” الهدهدُ ” يُقصرُ مِن طرْفِه الذي كان مصوبَهُ نحوي بتركيزٍ ، وراح يوزعه في جنباتِ الكشك الخشبي وأركانِه ، حتى السقفُ لم تفلتْ منه بقعةٌ مِن نظرِه واستكشافِه .. كان عليَّ أن أعيدَهُ إليَّ ، وأن أنسى بدوري كلَ أهوالِ المفاجئاتِ ، وأن أبدأ معه الحوارَ مباشرةً وبكلِ جِديةٍ :
ـ وأيُ قدرٍ سعيدٍ جئتَ مِن أجلِه ؟
لم يُجب الهدهدُ مباشرةً ، بل واصلَ استكشافَه لعالَمِ الكشك الخشبي وكأنه يعجبه رغم ما يمتلكُ من طبيعةٍ رحباء غنَّاء ، إلَّا أنه لم يُطِلْ ذلك حتى بدتْ لي كياستُهُ وفطنتُه ، وصرتَ أعتقدُ فيه أنه هدهدٌ حكيمٌ ورشيد إذ أراد بالتمهلِ في الردِ التهدئةَ ، وبطئ وتيرةِ الحوارِ ، وهاهو قد أعطاني وجهَهُ بالكليةِ قائلًا:
ـ ألا يجدر بك أولًا أن تتعرفَ عليَّ ؟
أخذ مني الطائرُ كلَ مأخذٍ ، فمع شدِ انتباهي الشديد بسؤالِه الذي كان وقعُهُ وقعَ الصفعةِ التي يُستفاقُ بعدها ، فإنه قد فتح مجالًا للتقاربِ الشخصي بيننا ، وأفقًا للحوارِ الجاذبِ الهادئ :
ـ أنت هدهدٌ كسائرِ الهداهدِ ، وبذلك أنت معروفٌ لدي ولا أعتقد أن لك اسمًا تُعرَفُ به .
راح الهدهدُ يعرفُني بنفسه ، فهو ابنُ الملكِ السابقِ لمملكةِ الهداهدِ ، الذي كان صديقًا لملكةِ النملِ ثم لي في مسرحيةِ ” وقالت نملة ” ، والذي مات أمامَ ناظرينا بعد عناءٍ شديدٍ في رحلةٍ شاقةٍ استكشفَ فيها المؤامرةَ على الإيمانِ ، وعلى الإسلامِ والمسلمينَ بفتنةِ كورونا ، وأنه الآن يشغلَ هذا المنصبَ الرفيعَ خلفًا لأبيه رغمَ صِغَرِ سنِه ، فهو ملكٌ ابنُ ملكٍ ، بل وحفيدًا لهدهدِ سليمان ، ذلك الذي أبهرَ العالمينَ بحديثِه وفعلِه .. فَرِحْتُ بهِ كثيرًا ، وزدتُ له في الترحيبِ وحُسنِ الاستقبالِ حتى أراد هو قطعَ الإسهابِ بسؤالِه :
ـ هل فطنتَ الآنَ لقدريةِ زيارتي لك يا سيدي ؟
ـ في الحقيقةِ كم صرتُ أخجلُ مِن لفظةِ ” سيدي ” هذه بعد أن عرفتَ أنك ملك .
ـ بل أنتم معشرَ البشرِ ملوكَ هذه الحياةِ الدنيا بما فيها من أحياءٍ وكائنات ، أما أنتَ سيدي الكاتب فلك عندنا قدرًا خاصًا ، حتى أننا لم نزل نتغنى بشعرك كما كان أبي يتغنى به .
راح الهدهدُ يتغنى بموالِ ” يا ليل يا عين ” حتى وقف فجأةً عند هذا المقطع الذي طالما صدحَ به والدُهُ في الفضاءِ ، وانتابته رِعشةٌ ، وظهر الوجومُ على وجههِ الذي انتقلَ إليَّ بدورِي في مشاركةٍ وجدانيةٍ طبيعيةٍ حيثُ لم أكن أدري ماذا حدث ، غيرَ أني لاحظتُ تحوِّلَ عينيهِ إلى ساعةِ اليدِ التي تلفُ معصمي .. راح يصوبُ فيها نظرَهُ بشئٍ مِن خوفٍ ورعبٍ حتى صرتُ قلقًا ومتضجرًا ، إذ لم أكن أشأ أن يتحولَ الانسجامُ عن الموقفِ الفريدِ من نوعِه ، والذي هو أشبه بمعجزةٍ حيث طائرٌ يقفُ أمامي ويكلمني .. في غيرِ شعورٍ مني مددتُ له يدي لأسأله عما أصابه الذعرُ بسببِها إن كان يعرفُ عنها شيئًا ، فكان رده يشوبه الحسرةُ والندامةُ مع شئٍ من هدوءٍ بعد أن تمالكَ نفسه :
ـ نعم ، إنكم تسمونها ” الساعة ” ، وكم هي قريبةٌ منكم حيثُ تضعونها في معصمكم .
لم أشعر إلَّا وشعر رأسي يقفُ من جديدٍ ، مع شدِ انتباهٍ عنيفٍ كما لو كنتُ تعرضتُ لشحناتٍ كهربائيةٍ لاسعةٍ ، إذ هل من دلالةٍ في قولِه ؟ .. رأيتُ أنَّ من الحنكةِ أن أعودَ به إلى مبتدأ حديثنا ، حيثُ الغرضُ من زيارتِه ، وحيثُ القَدَرُ الذي أتى بهِ إليَّ :
ـ لم تخبرني عن سببِ مجيئك ، وعن اختصاصي بهذا القَدَرِ الجميل .
راح يكلمني عما كان يشغلني إلى درجةِ الضيقِ والضجرِ ونفادِ الصبرِ وكان قد لاحظه عن قربٍ قبل مجيئِه ، فقد كانت الحَيْرةُ ستقتلُني حين كنتُ مستغرقًا في تفكيرٍ عميقٍ ، شابَتهُ لحظاتُ إفاقةٍ كان الطارقُ لها الرفضُ والإباءُ وكثيرٌ مِن طيفِ شكٍ فيما يخطرُ لي ببالٍ ، وفيما يروَّجُ له مِن إشاعاتٍ ، ومِن خزعبلاتٍ وأوهامٍ لم تكن لتقنعني تمامًا ، حيثُ فقْدُ اليقينِ فيما يُطرحُ مِن أسبابٍ ، وحيثُ فقْدُ التثبتِ مع كثرةِ التساؤلاتِ .. إذ كيف تجرؤ حكومةٌ مِن حكوماتِ العالَمِ أن تقتلَ شعبًا بكامِلِه ، أو حتى كيف تجرؤ أن تعرِّضَهُ للمرضِ ، ثم كيف يكون الإجبارُ على التلقيحِ مِن غيرِ ضرورةٍ في علمي ويقيني ويشملُ بشريةً بكاملِها ، رغم انتفاء الداعي ـ وهو المرضُ ـ عند الشخص الصحيحِ ، مما يفرضُ بقوةٍ فكرةَ وجودَ سرٍ لا ريب فيه .. نعم ، إن وجودَ سرٍ في اللقاحِ وعمليةِ التلقيحِ ذاتِها لهو أمرٌ بديهيٌ ومُسَلَّمَةٌ لا تُناقشُ ولا تُرد غيرَ أنها ليست واضحةً ، فالتجرؤ يعني المسالمةَ والأمانِ ، بيينما إجبار غير المريضِ إنما يوحي بالمؤامرةِ ويُدخلُ الشك .. أخذتْ مني الصيحاتُ تنطلقُ وتملأُ جنباتِ الكونِ بأسرِه ، تلك الصيحاتِ التي جاء على إثرِها زائري :
ـ أيُ سرٍ فيك يا لقاح .. أيُ سرٍ فيك .
هنا تكلم الطائرُ الجميلُ ، لقد ذابتْ كلُ تفاعلاتِ التوترِ السابقةِ ، وعاد بالكليةِ إلى هدوئِه وثقتِه ورباطةِ جأشِهِ ، تمامًا كما كان مِن قبلُ حيثُ البدء :
ـ السرُ يا سيدي في تلك المخازنِ تحت الأرضِ .
ـ مخازن ؟! .. أي مخازنٍ تحوي هذا السرِ الرهيب ؟
ـ إنها مخازنٌ تحوي السائلَ النتنَ الذي سيُدخله الشيطانُ في جسدِ ابن آدمَ عند استحقاقِ ذلك .
لقد انتفى وصفُ المفاجأةِ وذابَ ، عن كلِ ما مضى من مفاجئاتٍ أمام هذه المفاجأةِ وهولِها ، فلقد راح الهدهدُ يسردُ لي قصةَ إبليسَ مع ابنِ آدمَ فيما خفيَ منها ، منذ أن قطع بينه وبين ربه العهدَ والميثاقَ بإغواءِ أبناءِ آدمَ أجمعينَ إلَّا عبادَ اللهِ منهم المخلَصينَ ، حتى شرعَ مِن حينِها في بناءِ مخازنٍ كبنوكِ الدمِ واللبنِ للرُضعِ عندنا على حدِ تعبيرِ الهدهدِ ، ليضعَ فيها إفرازاتِه النتنةِ كنتانةِ جسدِه وخُلُقِه .. كان الهدهدُ متلجلجًا ومترددًا في تعينِ هذا السائلِ ووصفِه ، فقد كانت له مأمأةٌ كمأمأةِ الماعزِ فطنتُ منها أنه يريدُ كلمةَ ” ماء ” لكنه يتردد ، غيرَ أنه تحت ألحاحٍ مني وإصرارٍ لمزيدٍ من التوضيحِ قال :
ـ إنه السائلُ الذي إذا ذُكِرَ اكتستْ الوجوهُ بِحُمْرَةٍ .
ـ هذا عندك أنت وقومَك لنقائكم ، أما نحنُ فعندنا قاعدةٌ تقول ” لا حياءَ في العلمِ ” .
تشجع الهدهدُ أن يخبرني مع شئٍ من خجلٍ وحياءٍ ، ومع ترددٍ وخوفٍ غيرَ خافٍ من استغرابي وعدم تصديقي .
ـ أعلمُ يا سيدي ولقد أسماهُ النبيُ ” ماءَ الرجل ” ، كما ذكره الخالقُ في قصةِ خلقِ الإنسان فقال ” مِن مَنِّيٍ يُمنى ” ، كما أسماهُ أيضًا ” ماء مهين ” .
أخذ الذهولُ مني كلَ مأخذٍ ، ورغم خجلٍ شديدٍ أصابَ كلَ جوارحي مما لُطِخَ به بنو قومي ، حتى عيناي لزمتا الأرضَ خشوعًا ، وصارَ البصرُ خاسئًا غيرَ قادرٍ على النفاذِ والتصويبِ ، إلَّا أنني صحتُ فيه متجهمًا .
ـ ماذا تعني بقولِكَ هذا ، أتكذبُ لتسخرَ منا ؟
صمت الهدهدُ برهةً وأخذ ينظرُ عن يمينٍ ويسارٍ ، وكأنه أراد بذلك أن يمتصَ صيحتي وغضبي وتجهمي ، غير أنه رد بهدوءٍ وثقةٍ يشوبهما فجيعةٌ من اتهامي إياهُ :
ـ نحن قومٌ يا سيدي مجبولونَ على الصدقِ والفضيلةِ .
رُدَّ كيدي في نحري ، ولم أستطع النطقَ ببنت شفة ، وراح الخذلانُ يكسوني من رأسي لأخمصِ قدمي ، فلقد أفاقني بقولِه على حقيقةٍ مؤلمةٍ مفادها : ” أن الكذبَ وكلَ الرذائلِ ، إنما هي صفاتٌ اختَصت بها البشريةُ دون سائرَ الخلقِ ” .. وتحت هذا الخذلانِ الرهيبِ رحتُ أترجاهُ بعد اعتذارٍ أن يخبرني عما حدث لقومي جراء أخذِ اللقاحِ ، بما يعلم ولا نعلم حيث طبيعتُه وقدرتُِه في سَمَعِ ونَظَرِ ما لا نسمعُ نحنُ ولا نرى ، حتى انطلقتْ من فمهِ قنبلةٌ بحجمِ نفخةِ الصورِ .
ـ مما يؤسفُ له اليومَ أن البشريةَ متلبسةٌ بحملٍ غير شرعيٍ .. فهي حاملٌ بذريةٍ إبليسيةٍ سوف تقومُ عليها الساعةُ عما قريب .
أخذ الهدهدُ ينظرُ ثانيةً إلى الساعةِ في معصمي مما جعلني أعرفُ مدلولَ رعبِه السابقِ الذي لا يكونُ أبدًا سوى من مخلصٍ سليم الفطرةِ حين يتذكرُ الساعةَ ، غير أنه حولَ نظره سريعا إلى وجهي :
ـ لا تبتأس يا سيدي فأنت الكاتبُ والمفكرُ الذي يبحثُ عن مخرجٍ لقومِه في هذه الفتنةِ ، وعليك أن تحمدَ ربَّكَ أن جعلكَ في قومِك كهارونَ في قومِه حين فُتُنُوا بعبادةِ العجلِ .
بالحقِ أصابتني رِعدةٌ من هولِ تلك المقارنةِ ، إلَّا أنه كان ذكيًا في إخراجي من هولِ وسيطرةِ نتائجِ المفاجَأةِ من تفاعلاتٍ ومشاعرٍ متضاربةٍ ، ومن منطلقِ المسئوليةِ الجسيمةِ سألته عن جدوى إدخالِ هذا السائلِ النتنِ أجساد بني آدمَ فقال :
ـ ألا ترى معي الإصرارَ على تسميته ” لقاح ” .. إنها عمليةُ تلقيحٍ يا سيدي .
أخذ الهدهدُ يصولُ ويجولُ في بيانِ ذلك ، وكيف أن هناك أهدافًا عديدةً معنويةً وماديةً من وراءِ إدخالِ إفرازاتِ اللعينِ النتنةِ جسدَ ابنَ آدمَ ، تلك الإفرازاتِ التي تم جمعُها من جسدِ إبليسَ وقومِه منذُ بدءِ الخليقةِ ونسج قصة العداءِ ، إلى أن خرجت في موعدِها ليتم خلطِها بموادَّ كيميائيةٍ معينةٍ من شأنها أن تحققَ للخبيثِ كلَ أهدافِه ، التي من بينها استحقاق الجسد الآدمي الذي دخله نَتَنٌ من إبليسَ لنارِ جهنمَ ، لأنه ما كان له ولا لإفرازاتِه أن يدخلَ الجنةَ وإن انتقلتْ أبعاضُه إلى جسدِ مسلمٍ ، يا للحمقِ ، يا للحمقِ .. ورغم هولِ الكارثةِ شرعتُ في سؤالِه :
ـ تُرى ، أيُ استحقاقٍ استوجب فعل ذلك كله في هذا الزمنِ بالذات ؟
بألمٍ شديدٍ لا يقلُ عن ألمِ جده الأولِ لكفرِ ” بلقيس ” وقومها وعبادةِ الشمس من دونِ اللهِ ، تكلم الهدهدُ عن ذلك الاستحقاقِ باستفاضةٍ كغلقِ بيوتِ اللهِ في كاملِ الأرضِ ، وكتحريفِ صلاة الجماعةِ بالتباعدِ بين المصلينَ ، فضلًا عن تمكينِ إبليسَ ورفيقِ دربه ” شيطانِ الإنسِ الدجال ” من حكمِ العالَمِ ، ثم بإطاعتهما وقبولِ شرطهما للعملِ ولاكتسابِ الرزقِ ونسوا أن الرازقَ الأوحدَ إنما هو اللهُ لا شريكَ له ، حتى إبليسَ نفسه إنما هو مخلوقٌ مرزوقٌ بصفةِ الربوبيةِ التي لا تنفكُ عن مؤمنٍ ولا كافرٍ أبدًا ولا عن أي كائنٍ كان ، وكيف أن طاعةَ إبليسَ في ذلك إنما تعني عبادته والإشراك به .. ذهلتُ بصدقٍ لقولِ هذا الهدهدِ الذي لامس بقوةِ جذبِ مغناطيسٍ شغافَ قلبي :
ـ ما يدهشني منكم معشرَ الهداهدِ ، إنما هو دفاعُكمُ الدائمُ عن قضيةِ الإيمان .
ـ لولا الإيمانُ باللهِ ما خلق اللهُ ذلك الكونِ .
ـ صحيح .. صدقت ، ولكن هل هذه هي نهايةُ الأمةِ بعد أن وقعتْ في الشركِ وصارت تحت ولايةِ إبليس .
ـ بل أنتَ المنوطُ بالإجابةِ عن هذا يا سيدي .. فأنت الكاتب والمفكر ، وكم أنا شغوفٌ بسماعِها منك .
كان ردُ الهدهدِ مفحمًا لي بحقٍ ، إذ ليس لي سوى معرفةِ الخبرِ المخبوءِ منه ، أما العلمُ والاستقراءُ وما ينتجُ عنه من استنباطٍ ونتائجٍ فإنها لنا نحن .. كم نسيتُ نفسي أمام هذا البحرِ الهائجِ من أهوالٍ ومفاجئاتٍ :
ـ إطمئن صديقي الهدهد ، فأمتُنا ليستْ كالأممِ السابقةِ بل لها خصوصيةٌ في التوبةِ ، وهي مقبولةٌ بإذنِ اللهِ تعالى مالم تخرج الدابةُ ، وما لم يغرغر الفردُ عند خروجِ روحه ، إلًّا أن التوبةَ هنا مختلفةٌ ولها شكلٌ آخرَ .
تنفسَ الهدهدُ الصعداءَ ، ورأيتُ انبساطًا في أساريرِه طالما هناك توبةٌ مهما كانت كيفيتُها ، بينما أنا الذي دبَّ الوجلُ في قلبي حين وجدتُه يرغبُ في الانصرافِ ويستأذن .. حاولتُ برجاءٍ استبقاءه لكن عبثًا حاولتُ فهو أيضًا له ما يشغله في مملكتِه ، كما أنْ ليس بدٌ من انتهاءِ اللقاءِ والانصرافِ .. انصرف الهدهدُ خاطفًا معه قلبي .. طار قليلًا ثم حط فوق شجرةٍ قبالة النافذةِ ليرفعَ جناحَه الأيمن ملوحًا وكأنه يودعني .. ارتحتُ كثيرًا لهذه المحطةِ القصيرةِ التي فصلت بين الخروجِ وبين الذهاب الذي قد يكونَ أبديًا ، لكن مازاد سعادتي وانفتح له ثغري تبسمًا ، أنْ سمعتُه وهو ينطلقُ يتغنى بأشعاري كما كان يفعلُ أبوه :
( أعلمُ أنكِ .. ما كفرتِ قصدًا يا أُمة ، ولكن بسفهٍ .. كانت الغُمة ، شيطانا الإنسِ والجِنة ، يريدا خروجكِ مِنَ الملة ، وقد خرجتِ يا حلوة .. آهٍ منكِ يا أُمة ) .
ظل صوتُه الرقيقُ يترددُ على أذني نافذًا إلى قلبي مباشرةً ، ولم يزل ثغري متبسمًا وصدري منشرحًا .. حتى إذا ما خَفَتَ صوتُه وانقطع ، وبهتتْ صورتُه وتلاشت ، وجدتُ فجأةً الأرضَ تمورُ بي ، والسماءَ تكادُ أن تقعَ .. راحت أنفاسي تنقطعُ رويدًا وكأنه الموتُ ، ولا أدري ماذا حدث سوى ندمٍ شديدٍ وحسرةٍ على ما أصاب قومي خاصةً والبشريةَ عامةً ، سحقًا لهذا الجيلِ الأرعن الذي مكن إبليسَ من حكمِه ، وآهٍ من فجيعتك يا آدمَ في قبرِك .. صار صدري مُطْبقًا وكأن عليه جبلُ أُحدٍ ، وانقطعت أنفاسي تمامًا .. يبدو أنه الموتُ الذي جزعَتْ منه نفسي ، ياله من هولٍ ذاك الذي يصحبُ لحظةَ انتقالٍ إلى مصيرٍ مجهولٍ لا تعلمه وقد انتهت كلُ فرصةٍ لجعلِهِ حسنٍ ، إنها لحظةٌ يُقتلُ فيها كلُ غرورِ الإنسانِ .. صرتُ كالغارقِ الذي يريدُ أن يصرخَ لينقذه منقذٌ ولا يسطيع ، واستسلمتُ تمامًا للحظةِ النهايةِ لولا يدٍ امتدتْ إلى جسدي فأيقظتني من نومي ، فقد كان وكزُها شديدًا في جنبي وفي صدري ، إنها يدُ ” إسلامِ ” ابنِ أخي ذي الخمسةِ أعوامٍ ، الذي كان معي قبل أن تغفو عيني متكئًا على نافذةِ الكشكِ ، نظرتُ في عيني الطفلِ فرأيتُ فيهما ملامحَ فزعٍ واندهاشةٍ فعرفتُ أنْ كان لي في غفوتي صوتًا وحركةً .. تنفستُ الصعداءَ بعد أن تيقنتُ أنني حيٌ أُرزقُ ، وأن ما جرى لي ليس إلَّا كابوسًا أنقذني منه إسلامي حبيبي ..
ياسر شلبي محمود










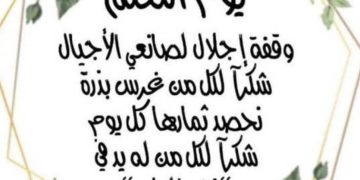



















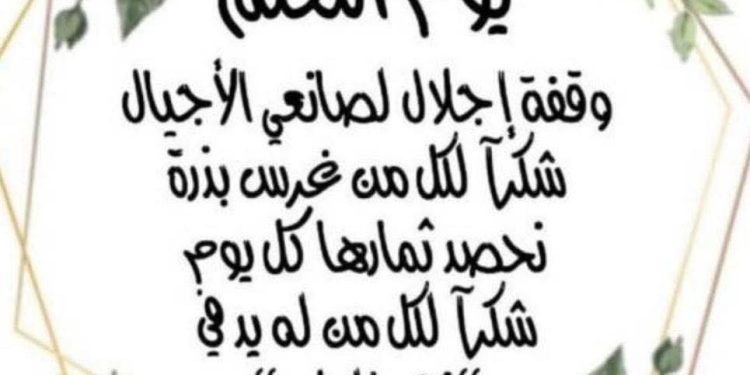








Discussion about this post