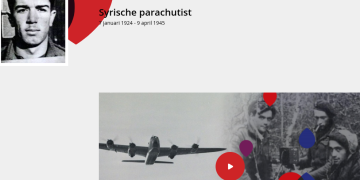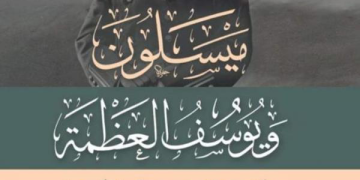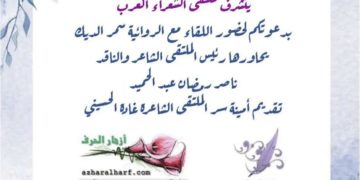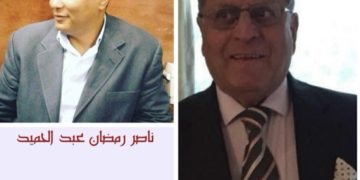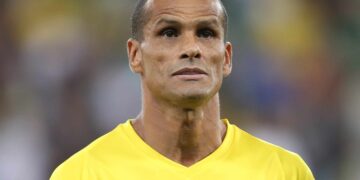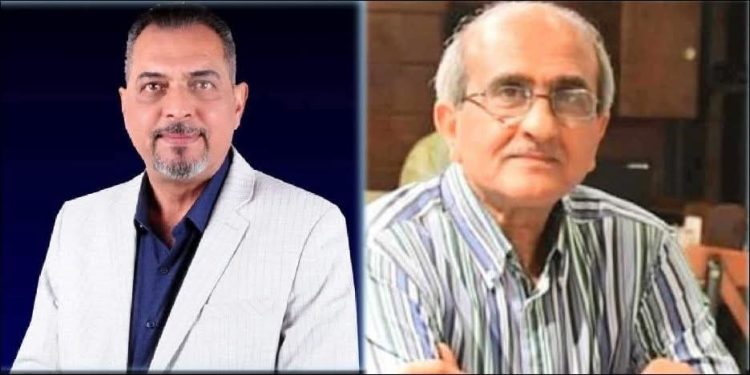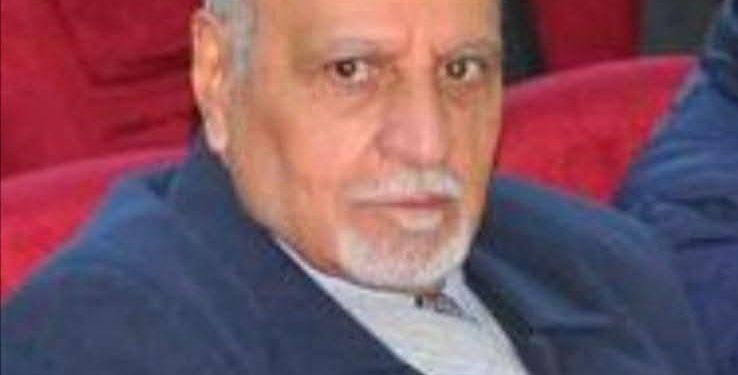Views: 7
قراءة نقدية لقصيدة (طقوس الحصاد) للشاعر قصي الفضلي.
(طقوس الحصاد)
قصي الفضلي
مدننا في حدائقِ البنفسج
تتقن الإصغاء للصمتِ
بعد إتمامِ طقوس الحصاد
حصاد سنابلَ وُهبتْ للريح
قد تضرب موعداً لعشاء أخير
مع العزلة
تعطّرُ كفَها الحالكة َ الضبابِ بالفراغ..
أجراس ُ الأبواب تقرع ُ
نشيدَ أوقات ٍ متعبة
فالخرابُ مقبلٌ نحو
أنفاسنا المثقلة ِ بالوَهن..
تباً …
للشعور ِ صوت يتنهد
في الأزقة السوداء
حيث الخوف طوفان لعنةٍ
تنثر ُ حمولتها في بيادرِ الفجرِ
دون أن تلقي السكينة بأحياء
يترقبون المددَ
في غمرةِ الصلاة…
العتبة /تحمل العنوان (طقوس الحصاد)
تناقضا داخليًّا يلفت الانتباه. فكلمة (طقوس) تُشير إلى أفعالٍ متكررةٍ ذات طابعٍ احتفالي أو ديني، بينما (الحصاد) يرتبط بالدورة الطبيعية للحياة (النمو، النضج، الانتهاء). لكن القصيدة لا تتناول الحصاد بمعناه الزراعي المادي، بل تحوِّله إلى استعارةٍ عن الخراب والضياع. هذا الانزياح يخلق توقعاً لدى القارئ عن نهايةٍ مُثمِرة، لكن النص يُفاجئه بحصادٍ من السُّنابل المُهْداة للريح؟ أي جهدٍ ضائعٍ لا يُجنى منه ثمر.
نستبط من الرؤيا الوجودية القاتمة التي تُجسِّد صراع الإنسان بين الفعل العبثي والخراب المُحدق. فتنسج القصيدة عالمًا مليئاً بالتناقضات الرمزية، حيث تتحوّل طقوس الحصاد التي تُعبِّر تقليدياً عن الخصب والعطاء إلى استعارةٍ للفقد والعدم.
وفي دلالة الثيمة للعنوان يَظهر تناقضًا بين الطقوس (المنظَّمة) الحصاد المُهدَر للريح، مما يُلمِّح إلى جهد إنساني بلا ثمر. تُصوَّر المدن ككائناتٍ صامتة تختبر فراغا وجودياً بعد انتهاء الطقوس، وكأن الإنجاز البشري محكومٌ بالزوال. وبانتقالة عفوية وجدانية حين يستنطق الشاعر/ العزلة والخراب/: تتحوّل العزلة إلى/عشاء أخير/ مع الذات حيث يُطرَّح الفراغ كعطر في كف مُظلم، ولعله رمزاً لمحاولة تزيين الوحشة بالعدم. فيقترن هذا بقدوم الخراب إلى أنفاسنا المثقلة بالوهن، ليُصبح الجسد والروح حمولةً للضعف. في حوار للذات والأنا للخوف والانتظار العقيم تُحوِّل القصيدة الفضاء الحضري إلى مكان مُخيف (أزقة سوداء، أبواب تقرع بأجراس التعب) بينما ينتظر الناس المدد خلال الصلاة دون جدوى، ناقداً بذلك الطقوس الدينية أو الاجتماعية الفارغة والمهترئة..
ومن الناحية الفنية في التوظيف للأدوات المستخدمة في عرفانية الشاعر كمفارقة
في التلاعب بحيوية الجُمل واستنطاق معانيها الحداثوية( كتعطّر كفّها بالفراغ) حيث يتحوّل الجمال إلى تعبيرٍ عن العدم.
ولا بد أن أُشير إلى الدينامية وتصويرها الحسي بالاعتماد على الألوان القاتمة (البنفسج، الحالك، السواد) والأصوات المُرهقة (تنهُّد الشعور، أجراس الأبواب) لخلق جوٍّ كابوسي. ليجعل المتلقي ملاصقا لماهية الانفعال، فيمتزج مطواعا في انتظار ما يؤول إليه حدث النص.
ومن الناحية الرمزية باستخدام (الريح) كقوّة تأخذ الحصاد (الهدر)، بيادر الفجر، التي تُنثر فيها اللعنات بدلاً من الحبوب، إشارةً إلى تحوُّل أماكن الإنتاج إلى ساحاتٍ للدمار.
في المُجمل تستحضر قصيدة الفضلي إحساساً باليأس المُعاصر، ربما تعكس واقعاً عربياً يعيش تناقضات بين الموروث الثقافي والانهزامات الحضارية. يُذكِّر الأسلوب بالشعراء الحداثيين مثل أدونيس، من حيث تفكيك الرموز التقليدية وإعادة بنائها في سياق تراجيدي. مما يضعنا بين نارين، فالنقد هنا موجّهٌ نحو الطقوس الفارغة اجتماعية كانت أم دينية التي لم تعد تُنتج سوى الخراب، بأشارة ذكية ألقى بها مكنون الشاعر وأزمةَ الوجود الإنساني في عالمٍ مُفككٍ، حيث تُحيلُ (طقوس الحصاد) بوصفها فعلًا زراعيًّا مرتبطا بالخلق والعطاء إلى استعارةٍ لسؤال المعنى في ظلّ العبث والعدم.
في المُجمل القصيدة عبر لغتها الكثيفة تطرح سؤالاً مركزياً كيف نُعطي معنى لوجودنا في عالم ينهار؟
إنها تُجسّد أزمة الإنسان الحديث الذي يحمل تراث طقوسٍ قديمة (الحصاد، الصلاة)، لكنه يعيش في واقعٍ مُثقَلٍ بالخراب والفراغ. الصورة الأخيرة، لـ الأزقة السوداء و، الخوف الطوفان، تُلخّص مصيراً وجودياً،.. الوجود الإنساني سجنٌ مُظلمٌ، تُعلّق جدرانُه على أجراس الأمل، لكنها لا تُصدِر سوى صوتَ الوهن.
علاء الدين الحمداني